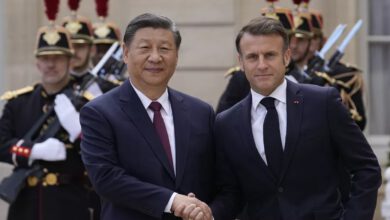بين حضن القمّة وقلب سوريا، خيارُ الواقعيّة

بين حضن القمّة وقلب سوريا، خيارُ الواقعيّة

حرِصت القيادةُ السوريّة على تسريبِ معلومةٍ في قمّة جُدّة تقول: إنّ الوفد السوري لم يضع سمّاعات الترجمة حين ألقى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي خطابه. وفي الحرص تبريرٌ لعدم خروج الوفد اعتراضًا، ذلك انّ الروابط الاستراتيجية الجامعة دمشقَ وموسكو منذ العام 2006، تفترضُ عدمَ تقبّل خطابٍ لائمٍ من زيلينسكي يُفنّد فيه ما وصفها بجرائم روسيا.
لكنّ الواقعية أبقت الوفد جالسًا ولو ممتعِضًا، وذلك فيما كانت الواقعيّة أيضًا تدفع الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين إلى بعث رسالةِ تهنئة إلى السُعُودية على نجاحِ حدثِ القمّة قائلاً: “إنّ مواصلةَ توسيع التعاون متعدّد الأوجه بين روسيا والدول العربيّة، يُلبّي مصالحَنا المُشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع نظامٍ أكثر عدلاً وديمقراطيّة، للعلاقات الدوليّة يقوم على مبادئ تعدّد الأقطاب والمساواة الحقيقيّة واحترام المصالح المشروعة للجميع”.
لم تكن روسيا بعيدةً عن إعادة اللُحمة بين العرب والأسد. لعلّ وثائقَ الغرف المُغلقة ستكشف يومًا، أنَّ الدبلوماسيّة الروسية من فلاديمير بوتين مرورًا بسيرغي لافروف وصولا إلى ميخائيل بوغدانوف، كانت المُبادِرة إلى الحثّ عن الانفتاح، واستمرّت تعمل على انجاحه حتّى عشيّة القمّة، خصوصا بعد أن سرت معلوماتٌ عن تردّد الأسد في الحضور، أو عن تهديدِ قادةٍ عرب بالمقاطعة لو حضر. تمامًا كما أنّ بعض هذه الدبلوماسيّة الروسيّة ينشط اليوم، بعيدًا عن الأضواء، لطمأنةِ بعضِ القلقين في لُبنان من خصومِ الأسد، على مستقبل العلاقة مع دمشق. فبوغدانوف نفسُه تواصل مع أصدقاء لُبنانيين في الآونة الأخيرة لهذا الغرض.
كانت ضربةَ معلّم تلك التي جمعت الأسد مع زيلينسكي تحت سقفٍ عربيّ واحد. لعلّها أكّدت العنوان العريض لاستراتيجية الأمير محمّد بن سلمان في الموازنة الدقيقة بين الشرق والغرب، فوليّ العهد الذي روّض عنجهيّة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لم ولن يعتبر يومًا أنَّ أميركا أو الغرب الأطلسي خصمان، وإنّما ردّ على مَن أراد أن يجعل ” السعوديّة دولةً منبوذة”، بأنْ جعلها عبر التحالف مع الصين وروسيا، ومن خلال تصفير المشاكل مع إيران وتركيّا، والمصالحة مع قطر، والبدء بإنهاء حرب اليمن، وطيّ صفحة الخلاف (الذي ورثه) مع الأسد، دولةً مقصودةً ومرصودةً وربما محسودة أيضًا، ينشد الجميعُ رضاها.
السياسة الواقعيّة كذلك، هي التي دفعت الأسد لإلقاء خطاب هادئ، لا اتهامَ فيه لأحد ولا عداءَ سوى لإسرائيل ولِما وصفه بخطر الفكر العثمانيّ التوسعيّ المطعّم بنكهةٍ إخوانية منحرفة. وهي الواقعيّة نفسُها التي جعلت البيانَ الختامي للقمّة، يتجنّب كلَّ كلامٍ عن وجوب حلّ سياسي في سوريا، والاكتفاء بالحديث عن الحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية واستئناف دورها الطبيعيّ في الوطن العربيّ.
لا شكّ في أنّ التفاهمَ الإيراني السعودي في الصين، سهّل وسرّع استعادة العلاقات السُعودية السورية، لكن لا بُدَّ من النظر إلى الأمر من زاوية أخرى أوسع وأشمل. فالأمير محمّد الذي رسّخ شعبيته الداخليّة بإصلاحاته الاستثنائية، ووازن سياسته الخارجيّة بين الغرب والشرق، وصفّر المشاكل مع الجيران، قد وضع في قمّة جُدّة اللبنات الأولى لمشروعٍ عربيّ ستكون السعودية في طليعته، ولخّصه بجملٍ قصيرة أبرزها :”نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أنّنا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقّق مصالحَ شعوبِنا، ويصون حقوقَ امّتنا، وأنّنا لن نسمح بأنْ تتحوَّل منطقتُنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طيّ صفحة الماضي، تذكّر سنواتٍ مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبُها وتعثّرت بسببها مسيرةُ التنمية”.
ولو أضفنا الى هذا التشخيص، ما قاله الأمير محمد عن أنّ ” القضية الفلسطينيّة كانت وما زالت قضيّة العرب والمسلمين المحوريّة، وأنّها تأتي على رأس أولويات سياسةِ المملكةِ الخارجيّة” ، يُمكن أن نتلمّس بشائرَ مشروعٍ عربيٍّ قابلٍ لطيّ صفحة الصراعات، وواعدٍ بالاتجاه نحو التنميّة والاقتصاد وقادرٍ على جمع العرب من الحضن الى القلب ( حتّى ولو أن الأسد اعترض على عبارة الحضن) ، ذلك أنّ تقلّبات العالم والمخاطر المُحدقة بالعرب بعد حربِ أوكرانيا، وقبيلَ حروبٍ أخرى قد تكون أشرس، خصوصًا اذا ما نظرنا إلى توجّهات قمّة مجموعة السبع اليوم في هيروشيما، حيال الصين وروسيا، تفرضُ الخروج من عصر الفتن العربيّة-العربيّة، مع كل ما تطويه من جراح ومظالم، ووضع مشروع عربيّ واضح وفعّال لمواجهة المراحل المُقبلة.