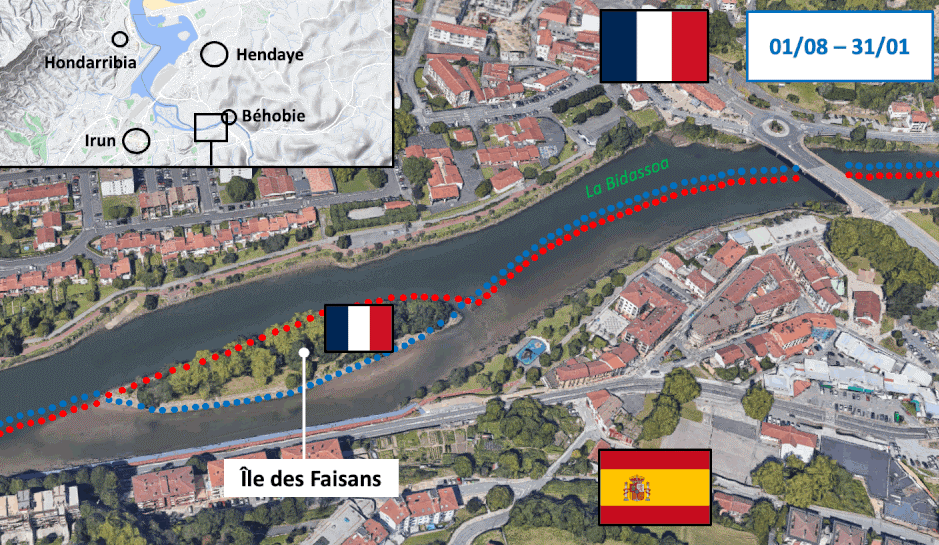ثقافة ومنوعات
الموت من أكل الجُثّة الى العصر الافتراضي

مع أن الموت هو اليقين الوحيد في حياتنا، إلا أن طريقة مواجهته تختلف بين الثقافات والمجتمعات والأفراد. وفي عصرنا الافتراضي، صار للموت قصةٌ أخرى، فما هي أساليب الطقوس الجنائزيّة وكيف تغيّر الموت؟
– ترجمة: منعم بن دائخة. ( كاتب ومترجم ليبي)

مع أن الموت هو اليقين الوحيد الذي ندركه منذ اللحظة الأولى التي ندرك فيها الحياة، فإن كل الثقافات تقدم أنماطا خاصة بها لسرّ الموت عبر طقوس جنائزيّة مختلفة.
بحسب هيرودوت، فإن هنود الكلاتياس شعروا بالرعب حين عرفوا أن الإغريق كانوا يحرقون جثثهم، فالهنود اعتادوا على أكل جثث موتاهم. وطقوس الجنازة قديمة كقدم ظهور الإنسان على وجه الأرض. أول من مارس الطقوس إنسان نياندرتال الذي عاش بين ٢٣٠ ألف و٤٠ ألف سنة مضت. وجد ذلك في موقع أثري اسمه “لافيراسي” في مقاطعة دوردوني بفرنسا [بداخله كهوف وملاجئ صخرية معروفة]. عثر علماء الآثار على عدة هياكل عظمية مدفونة، بما في ذلك هيكل لطفل يبلغ من العمر عامين.
يعد “ستونهنج” إحدى أهم المعالم الأثرية الجندلية في العالم الذي بني ما بين عامي ٣١٠٠ و٢٠٠٠ قبل الميلاد، وفيه حوالي ٢٥ جثة. وفي القرن الحادي والعشرين وفي جزيرة سولاويزي الأندونيسية كان التورانيون ينبشون موتاهم كل ثلاث سنوات: يمشون بهم ويغيرون لهم ملابسهم ويعيشون معهم لفترة من الزمن!
والحال، أن الموت في أوروبا وآسيا وأفريقيا مختلف تماما بين القارات. كما أن الموت في مدينة يختلف عن نظيره في بيئة ريفية، كذا موت المؤمن ليس كموت الملحد.
وترى الأديان -اليهودية والمسيحية والإسلام- الموت نتيجة لعقاب إلهي، مشبع بطابع مؤلم وتراجيدي، لكن الإغريق والرومان أدركوا الأمر ذاته قبل هذه الاديان، فهم ماتوا حين سرقوا التار التي صنعتها برونيثيوس من الآلهة. إذا، فاحتمالية الموت شيء مرعب.
ومع هذا، ثمة حالات أخرى ليست من ذات المنظور. نجد في الهندوسية أن الموت عبارة عن مجرد انتقال: يذبل الجسد حتى تحين اللحظة الذي تحتاج فيه الروح إلى روح جديدة، سواء أكان ذلك أفضل أم أسوأ، تبعا لاعتقاداتهم . وعلى كل فإن الموت عبارة عن سلسلة جديدة: إذا تحقق الكمال التام، فلن يكون ثمة داع للعودة إلى العالم، بل سيدخل المرء إلى el Suarga [جنة الأبرار]، وعلى العكس، إذا كان الإثم شديدا، فلن تكون ثمة فرص جديدة أيضا: ثمة Naraka: الجحيم [عالم سفلي] سيكون في انتظارنا.
وفي المجتمعات الغربيّة المعاصرة نتخلّص من الموتى بأسرع قدر ممكن. أمسى الموت شأنا قذرا لا طعم له، لا بل صار من التابوهات الملموسة. قال الفيلسوف جان بورديل: “من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات الحديثة، التطور دائم شيئا فشيئا، يتخلى الموتى عن الوجود”. عفا الزمن عن بعض الاحتفالات، كالسير مع الموتى أو الموت البطيء داخل المنزل أو الوقوف الطويل مع الجنازة. حظرت طقوس أخرى، كمرور موكب الجنازة وسط المدن، أو الدفن في قطعة أرض خاصة بالميت، مما يبين أن المجتمع الرأسمالي لا يرتاح مع الاستراحة للحظات: فالموت فعليّا هو إجراءٌ شكلي فحسب، ينبغي أن يسرٍع فيه حتى تستمر الحياة “يستمرّ الجميع في الأكل”.
يظل الألم عند من يشعر بالفقدان، لكن يحتمل إيجاد أقراص لهم. لم يُعد ينظر للموت على أنه عمليّة تجديد للأجيال، ولكنه النهاية الحتمية -والمفاجئة دوما- للفرد.
واقعيّا لم يعد الحزن شائعا وجماعيّا، بل صار فرديّا. ومع هذا، لا يزال دور الطقوس الجنائزية موجودا. فهي تساعد على توجيه المشاعر الإنسانيّة حيال فقد الآخرين -الخطر والألم والغضب والعجز- وتقوية أواصر التضامن. وبهذا الأسلوب تعمل الطقوس على تقوية أواصر الأخوّة، لمصاحبة الشخص المنهار في مواجهة قسوة الفقدان.
فمثلا، أمهات الشامبانزي يحتجن إلى شهور للانفصال عن صغارهن -كما تقول جين جودال- حين يموتون. وقد أكدت الدكتورة كارين ماكومب أنّ شيئا مشابها يحدث مع الفيلة التي تتعرف على جمجمة وأنياب الآخرين الذين تشاركوا حياتهم معهم، وتتفاعل معهم، وتدفنهم بأوراق الشجر وتبدو عليهم أعراض حزن واضحة. أما طيور العقعق الأوراسي والدلافين فهي ترافق في مواكب جنائزية رفاقها الموتى.
ومع هذا، لا يدل كلّ شيءٍ على الحزن: فمدينة نيو أورلينز تقيم احتفالات جنائزيّة بالجاز ومع فرقة موسيقية ترافق التابوت إلى المقبرة. في طريق العودة يطلق العنان للموسيقى؛ فالروح حينها تستريح فعليا. وفي غانا يأتي المجتمع بأكمله ليأكل ويرقص ويقدر نعش الميت، والذي عادةً ما يجهّزه النّجارون في المنطقة. لكنّ المشهور هو يوم الموتى الذي تحتفل به المكسيك، وقد صنّفته منظمة اليونسكو على أنه تراث ثقافي وحضاري. يذهب المكسيكيّون إلى المقابر محمّلين بالطعام لقضاء يومهم عند قبور ذويهم، وهم يغنون ويروون الحكايات عنهم. وفي ذلك اليوم يخبزُ خبز الموتى “مكون من: دقيق القمح، والحليب، والبيض، والخميرة، والسكر، والملح، والزبدة، مع قليلٍ من اليانسون والبرتقال” وكذلك يتم تحضير “جماجم الفينيق ” وهي حلوى مصنوعة من السكر والشوكولاتة وكذلك القطيفة التي يعود تاريخها للقرن ١٦”.
في الآونة الأخيرة وكنتيجة طبيعيّة لاستعمار التقنيات الجديدة، صار بامكاننا استخدام مصطلح جديد: الموت في العصر الرقمي. إنّ عبارات ” حسابات تذكارية” أو “طقوس الموتى الالكتروني” أو “المقابر الافتراضية” أو “الوصايا الافتراضية” ليست غريبة بالنسبة لنا: من الممكن اليوم فتح مدونات أو محادثات أو منتديات لتذكر من غادر؛ فالموت، مرة أخرى معروض للجمهور. لم يواجه مارك زوكربيرغ مخترع “فيسبوك” أي مشكلة في أن يتحول إلى حفار قبور افتراضي عبر تقديم ما يسمى “الحسابات التذكارية” لمستخدميه، مصممة بحيث يستمر أقارب المتوفي في الكتابة إليه إلى أبد الأبدين. اكتب له، أو اترك له أغانٍ وصورا وفيديوات كمفاجأة مدهشة ولا محدودة. حتى أنّ ثمة تطبيقات كتطبيق Enterni.me والذي عبر خوارزميات الحاسوب المطبقة على البصمة الرقمية للشخص الميت، يكرر شخصيته وينشأ ألبوما لصور رمزية ذكية تغذّي حسابه الشخصي. وبعبارة أخرى: الموت في العصر الرقمي لا يعني الموت إطلاقا. عش لترى.
إيستر بيناس دومينغو، كاتبة وشاعرة إسبانيّة.
– ترجمة: منعم بن دائخة. ( كاتب ومترجم ليبي)
مجلة الاخلاق الاسبانية